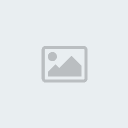جاء يوم رأت فيه الأجيال الحالية وما سبقها من أجيال تعاقبت على مصر بعد انقلاب يوليو 1952 مرشدا عاما للاخوان المسلمين يحمل لقب "سابق" وهو على قيد الحياة. هذا فأل خير نتمناه لمصر كلها، من أعلى هرمها السياسي، إلى كل مناصبها العليا والعامة.
من العجيب أن هذا التغيير جاء بواسطة الحركة الإسلامية التي يُتخوف منها على التنوير والدولة المدنية، والتحول إلى نظام ديني يعادي الحريات وتداول السلطة ويكفر الديمقراطية.
فزاعة النظام دائما أن الإخوان إذا تسلموا السلطة فلن يتركونها للتداول ولن تكون هناك ديمقراطية على الاطلاق. لكنهم نجحوا خلال أقل من شهر واحد في اختبارين بالغي الأهمية، الأول عندما لم تنجح شخصيتان شهيرتان هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد حبيب، ومن ثم جاءت إرادة الناخب فوق الأسماء، والثاني انتخاب الدكتور محمد بديع مرشدا ثامنا للجماعة في حياة المرشد السابع محمد مهدي عاكف الذي سيتمتع من الآن وصاعدا بلقب المرشد السابق.
لم ينتبه أحد حتى الآن لقيمة ما حدث من تغيير، بل ظلت فكرة التصادم مع الأمن هي المسيطرة، فعندما خرج أبو الفتوح، تحدث الجميع عن سيطرة المحافظين وازاحة الحرس الجديد، ما يعني تعضيد العمل السري والانسحاب من السياسي، وأمس جاء بديع وهو واحد من أفضل مائة عالم عربي تم اختيارهم عام 1999.
كأنه يجب أن تتمخض انتخابات الاخوان عمن يرضى عنه الأمن ومن لا يتصادم مع السلطة التي لا تحتاج إلى بديع أو غيره لكي تستمر في عمليات كسر العظم، فهي مرتاحة لمصطلح "المحظورة" ولن تسمح بتجاوزه حتى لو سيطر من نسميهم "الحرس الجديد" على الجماعة تماما.
كلمات بديع الأولى بعد انتخابه مرشدا عاما لم يلفت المحللون منها إلا عدم إشارته لامكانية تولي قبطي أو إمرأة رئاسة الجمهورية، وهذا لا يستحق الاشارة، ويجري التركيز عليه في إطار تشديد الخناق، فالجماعة بعيدة عن العمل السياسي المباشر منذ تم حظرها عام 1954 وفي غيبتها لم تفكر النظم التي تولت مصر في اسناد الرئاسة لأي من الاثنين، فالغالبية العظمى من المجتمع مسلمون، ما يتعذر معه منطقيا وانتخابيا أن يحكم غير مسلم، وذلك سمعناه غير مرة من البابا شنودة، بالاضافة إلى التقاليد الراسخة التي يستحيل معها أن يكون الرئيس إمرأة.
الأفضل أن ننظر إلى النقاط الايجابية التي لمسناها في حديث محمد بديع وليس إلى الخيال السياسي، فقد دعا بحماس إلى الديمقراطية وفصل السلطات، وأدان العنف وخصوصا الطائفي، والأهم هذا النص الواضح الذي ننقله بالحرف الواحد "النصارى يمثلون مع المسلمين نسيجا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا واحدا تداخلت خيوطه وتآلفت ألوانه وتماسكت عناصره عبر القرون".
لن يهتم المحللون هنا إلا بقوله "النصارى" وسيتساءلون "لماذا لم يقل المسيحيين أو الأقباط". تماما مثلما نسوا أنه عالم كبير وأستاذ في كلية الطب البيطري، ولم يتذكروا منه إلا القبض عليه عام 1964 في قضية سيد قطب التي أمضى بعدها 9 سنوات في السجن، فقالوا إنه كان عَضّوِا في التنظيم السري الذي اتهم عام 1965 بمحاولة قلب نظام الحكم، وبالتالي يهدد بعد توسده قمة هرم الجماعة بعودتها إلى العمل تحت الأرض!
لم يتوقفوا كثيرا عند تأكيده بأن جماعته ستواصل العمل النقابي والبرلماني والأهلي، إنما اغرقوا تحليلهم بسيطرة الجناح المحافظ الذي سيؤدي إلى مشاركة أقل في العمل السياسي.
جميع المحللين توقفوا ببديع عند منتصف الستينيات وجمدوه فكريا عندها وهذا منطق باطل في التحليل والاستنتاج، ينسجم مع تجميدهم للجماعة في التنظيم السري، مع أنه لا التاريخ ولا الممارسة منذ أخرجهم السادات من السجون يؤدي إلى تلك النتيجة.
الجماعة التي انتخبت مرشدا جديدا قبل أن ينتقل سلفه إلى جوار ربه، ولم تستهوها ديمومة الكراسي التي صبغت الحياة السياسية المصرية طوال أكثر من نصف قرن، تستحق تحليلا محايدا أعمق متخلصا من الأهواء والأمزجة والأحكام المسبقة.